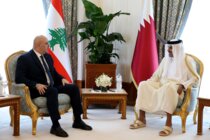قبل أسبوع من موعد تنصيبه رسمياً رئيساً للولايات المتحدة، كشف دونالد ترامب ووزراؤه ومساعدوه تباعاً أهداف سياسته في الداخل والخارج. ففي مؤتمره الصحافي وأمام لجان الكونغرس تحدّث الرئيس الأميركي المنتخب ثم وزراؤه ومساعدوه المرشحون لحقائب الخارجية والدفاع ولرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية «سي أي آي» عن التحديات التي تواجه أميركا ورؤاهم لكيفية مواجهتها. ما تلفّظ به هؤلاء جميعاً يطرح سؤالاً عمّا تبقّى لترامب ليقوله في خطاب التنصيب يوم الجمعة المقبل.
ترامب معروف بتقلّبه ونزقه ولن يستصعب تالياً أن يقول يوم تنصيبه أموراً مناقضة لما تفوّه به سابقاً، وما أدلى به وزراؤه ومساعدوه لاحقاً أمام لجان الكونغرس. مع ذلك، لا بأس في بيان بعض ما قاله وقالوه ومقارنته بأقوال ومواقف للرجل الذي سيحكم أقوى دول العالم لمدة أربع سنوات مقبلة في الأقل.
كان ترامب قد أعرب عن إعجابه ببوتين مراراً خلال حملته الانتخابية لدرجة أنّ موقع «بازفيد» اتهمه بامتلاك روسيا ملفات عنه تتضمّن فضائح إباحية تمسّ موقعه الرئاسي، وأنّ ذلك يفسّر موقفه المتوجّس والمتودّد من الرئيس الروسي. ترامب لم يتحمّل هذا الاتهام المهين ولم يكتفِ بنفيه، بل أرفق به تأكيداً بأن «لا علاقة لي بروسيا ولا يوجد عقد ولا قروض ولا شيء إطلاقاً ولا صداقة مع روسيا، لأنّ بيننا خلافات على المصالح».
مرشح ترامب لحقيبة الخارجية ريكس تيليرسون كان أقلّ ترفقاً ببوتين من رئيسه. قال أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس إنه لا يستبعد دوراً روسياً في الاختراق الالكتروني للانتخابات الأميركية، مرجّحاً ان يكون الرئيس الروسي أعطى ضوءاً أخضر لهذه الغاية. كذلك بدا تيليرسون أكثر تشدّداً مع روسيا من ترامب بانتقاده «استيلاء بوتين على شبه جزيرة القرم»، مؤكداً انّ روسيا الآن تشكّل خطراً، وأن «من حق حلفائنا في الحلف الأطلسي أن يقلقوا من بروزها مجدّداً». كما تميّز تيليرسون عن ترامب بموقف أكثر تشدّداً من الإسلام الراديكالي وأكثر ليونة حيال حلفاء أميركا الخليجيين. قال إنه يقتضي «إعادة بناء ارتباطاتنا القديمة والهشة الآن، والتشدّد مع خصومنا والردّ على انتهاكاتهم للاتفاقات»، كما وضع تنظيم الإخوان المسلمين و»عناصر في إيران»، وتنظيم «القاعدة» ضمن سلّة «التطرف الإسلامي».
مرشح ترامب لحقيبة الدفاع الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس ومرشحه لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو اتخذا أمام الكونغرس مواقف مغايرة لرئيسهما في مسائل جوهرية بينها دور الاستخبارات الأميركية والسياسة التي تنتهجها روسيا.
ماتيس أعلن، خلافاً لترامب، التزامه الاتفاق النووي المبرم مع إيران والدول الست، مشدّداً في الوقت ذاته على وجوب الردّ على «خروقها الصاروخية البالستية»، متهماً الرئيس الروسي بالسعي الى تفكيك الحلف الأطلسي، وداعياً – خلافاً لترامب – الى «ترميم التحالف مع الدول العربية الخليجية». كما دعا ماتيس الى «استعادة العلاقات مع إسرائيل وكأنها مقطوعة اصلاً! والسعي الى حلّ النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي»، مؤكداً انّ النظام العالمي يواجه «أضخم هجوم منذ الحرب العالمية الثانية»، ومحمّلاً روسيا والصين وتنظيمات إرهابية دولية مسؤولية اتجاهات وممارسات مزعزعة للاستقرار. غير انّ أهمّ «اعترافاته» أمام الكونغرس قوله إنّ الجيش الأميركي ليس مستعداً تماماً لمواجهة هذه التحديات كلها.
بومبيو كان أكثر صراحةً وتشدّداً من زميله ماتيس. أكد ضرورة مواجهة روسيا، ووصف إيران بأنها «دولة قيادية في رعاية الإرهاب»، وانّ الحرب في سورية أنتجت «أسوأ الأزمات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، وأدّت الى تفاقم التطرف والمذهبية وعدم الاستقرار في المنطقة وأوروبا، والى أسوأ أزمة للاجئين في التاريخ الحديث».
من مجمل ما أدلى به وزراء ترامب ومساعدوه يتضح انّ كلهم التقوا معه على إدانة الإرهاب وضرورة التشدّد في مواجهته، لكن أياً منهم لم يرتقِ الى مستواه في تحميل الولايات المتحدة خلال رئاسة أوباما مسؤولية إنتاج تنظيم «داعش» ورعايته، وإن كان كلهم أكثر تشدّداً منه حيال روسيا والصين. لكن اللافت انّ ماتيس خالف ترامب في مسألة الاتفاق النووي اذ دعا الى التزام بلاده به لأنه «عندما تلتزم الولايات المتحدة كلمتها عليها أن تحترم هذا الالتزام وأن تعمل مع الحلفاء للتأكد من تطبيق الاتفاق».
لماذا كشف ترامب الكثير من أهدافه قبل خطاب تنصيبه؟ لماذا سمح بهذا التباين في المواقف من بعض القضايا الأساسية بينه وبين وزرائه ومساعديه؟ هل هو نتيجة تفاهم مسبق بينه وبينهم، كما ادّعى، لتمكينهم من «إبداء وجهات نظرهم الخاصة»؟ هل هو نتيجة تقلّبه في الرأي والنوازع؟ أم هو نتيجة مراعاته ووزرائه لالتزامات قديمة لأميركا حيال حلفائها كما حيال خصومها، ما يستوجب تدوير الزوايا حفاظاً على مصالح أساسية؟
ثمة أجوبة متعدّدة لهذه الأسئلة المحيّرة. لكن الأمر الثابت انّ أميركا والعالم سيكونان، خلال عهد الرئيس الأدنى شعبيةً بين الرؤساء الأميركيين في تاريخ الدولة الأقوى في العالم، في حال ترقّب دائمة لمفاجآته الكثيرة والمثيرة في الداخل، كما في الخارج، وأنّ ذلك يشكّل، من بين أمور أخرى، أحد أبرز الأدلة على انّ النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية ماضٍ الى أفول، وأنّ نظاماً عالمياً مغايراً وملتبساً يولد من جديد.