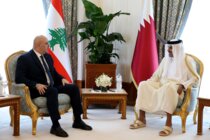من دون مقدّمات حتى بروتوكولية، عادت مصر إلى سورية أخيراً. العودة كانت من طريق روسيا. هذا، بادئ الأمر، ما حَدَث في العلن. ماذا في الباطن؟
العودة سلكت مسارَ ما يُسمّى إقامة «مناطق خفض التصعيد». روسيا هي صاحبة المبادرة في هذا المجال، والولايات المتحدة وافقتها وواكبت جهودها، ولا سيما ما يتعلّق منها بمنطقة «خفض التصعيد» في جنوب سورية، أيّ في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء تحديداً. من الطبيعي أن يكون لواشنطن دور في هذه المنطقة، لأنها مجاورة للجولان الذي تحتله «إسرائيل». من دون موافقة أميركا يصعب على روسيا نيل موافقة «إسرائيل» أو، في الأقلّ، ضمان سكوتها.
«إسرائيل» لم تُبدِ، في الواقع، موافقةً على منطقة خفض التصعيد المستحدثة بل مجرد سكوت في الشكل سرعان ما أتبعته باعتراض في المضمون، ذلك أنّ لديها شروطاً ومطالب لم توفّرها لها موسكو وإنْ كانت وعدت واشنطن بدراستها لاحقاً. أبرز الشروط عدم السماح بوجود تنظيمات للمقاومة، سواء سورية أو لبنانية، في المنطقة المحاذية للجولان المحتلّ. أبرز المطالب تقليص، إنْ لم تكن إزالة، نفوذ إيران من سورية. الشرط المذكور آنفاً مقبول مبدئياً من موسكو في هذه المرحلة. المطلب المنشود لاحقاً مرفوض لأنّ موسكو غير موافقة عليه أو غير قادرة على تنفيذه.
الجديد والمفاجئ في مسألة إقامة مناطق خفض التصعيد ليس ما تمّ في جنوب سورية، بل في محيط العاصمة دمشق. فقد تبيّن أنّ لمصر دوراً جدّياً في توليف وإعلان إقامة منطقة لخفض التصعيد في غوطة دمشق الشرقية. لماذا لمصر دور في هذه المنطقة وليس في غيرها؟
لأنّ التنظيمات المسلحة الناشطة فيها، وأبرزها «جيش الإسلام»، تدعمها السعودية بالدرجة الأولى. وبما أنّ السعودية موافقة، ضمناً،على إقامة مناطق خفض التصعيد، فقد أصبح في وسع مصر، صديقة السعودية في العلاقات الإقليمية وحليفتها في مجابهة غريمتها قطر، أن تدلي بدلوها في الساحة السورية من دون أي تحرّج ذاتي أو ملامة خليجية.
دور مصر في الساحة السورية، تحديداً في محيط دمشق، يوحي بأنه بالوكالة عن السعودية وليس بالأصالة عن نفسها. في الواقع، إنه الإثنان معاً. نعم، القاهرة تقوم بما تقوم به في الغوطة الشرقية بطلب علني أو ضمني من الرياض، لكنها تقوم به أيضاً، والأرجح بالدرجة الأولى، انطلاقاً من مصالحها الذاتية ومتطلبات أمنها القومي.
ليس سراً أنّ لمصر عقيدة استراتيجية قوامها انّ الأخطار وبالتالي الهجومات التي تعرّضت لها كان مصدرها غالباً الشرق. من هنا ينبع حرصها دائماً على أن يكون لها وجود سياسي وأمني فاعل في بلاد الشام، وإذا تعذّر ذلك، فلتكنْ لها تحالفات وازنة مع قوى سياسية وعسكرية في إحدى دول المشرق العربي. ما أملى على مصر في عهد جمال عبد الناصر تسريع وحدتها مع سورية وإقامة الجمهورية العربية المتحدة ليس الدافع القومي أو العاطفة القومية بقدر ما كانت ضرورات أمنها القومي الاستراتيجي. أليس لافتاً أنه بعد 54 عاماً على انهيار الجمهورية العربية المتحدة ما زالت مصر تعتبر الجيش السوري هو «الجيش الأول» وأنّ تسمية قواتها المسلحة تقتصر على مصطلحيّ «الجيش الثاني» و«الجيش الثالث»؟
مصر توّاقة الى استعادة دورها العربي والإقليمي لضرورات أمنها القومي الاستراتيجي. في هذا الإطار يقتضي تفسير حرصها على أن يكون لها دور في هندسة وضمان تنفيذ منطقة خفض التصعيد في غوطة دمشق الشرقية. هذا مع العلم أنّ مصر، وإنْ كانت قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سورية في ذروة الحملة الخليجية عليها، إلاّ أنها كانت تدعو دائماً وتشدّد على ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها ومعارضة ايّ مخططات ترمي إلى تقسيمها.
إلى ذلك، ثمة دافع سياسي قوي يحمل القاهرة على الاضطلاع بدور وازن في سورية. إنه تصفية حساب قديم مع قطر التي تتهمها برعاية الإخوان المسلمين وتمويلهم وتغطيتهم إعلامياً. كما أنّ دعم مصر لسورية هو فعل مجابهة سياسية وأمنية لتركيا الحريصة أيضاً على احتضان الإخوان المسلمين، المتّهمين بدورهم بأنهم مشاركون، بأشكال متعددة، ليس بمحاربة الدولة السورية فحسب، بل ضالعون أيضاً في الحرب التي تشنّها التنظيمات الإرهابية على مصر عموماً وفي سيناء خصوصاً. لذا فإنّ دور مصر المستجدّ في تنفيذ منطقة خفض التصعيد بغوطة دمشق الشرقية لا يُعتبر إسهاماً في الحرب على الإرهاب فحسب، بل استجابة أيضاً لمتطلبات أمن مصر الداخلي الذي يهدّده تحالف الإخوان المسلمين مع تنظيمات الإرهاب القاعدي في سيناء وفي أنحاء أخرى من أرض الكنانة.
باختصار، إنّ ما تقوم به مصر أصالةً عن نفسها واستجابةً لمصالحها يبدو مرجَّحاً على مقولة أنّ ما تقوم به هو بالوكالة عن غيرها.