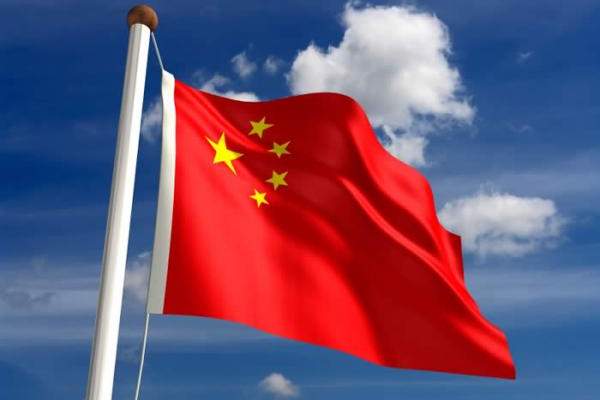لم يكن مفهوم «صراع الحضارات» المفبرك والمفتعل الذي روج له المفكر لأميركي صامويل هنتنغتون في كتابه، الذي كانت قد نشرته مجلة فورين أفيرز الأميركية عام 1993، لم يكن في حقيقته صراعاً بين الحضارتين الغربية والإسلامية، بقدر ما أن هدفه كان اختراع عدو جديد للغرب، بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفياتي السابق، لتبرير استمرار الدول الغربية الاستعمارية في سياسات فرض الهيمنة تحت حجة مواجهة التطرف الإسلامي،
العدو الجديد الذي افتعلته عبر تصنيع تنظيم القاعدة واستخدامه لاستنزاف القوات السوفياتية في افغانستان، ومن ثم لتبرير شن الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان والعراق، أثر هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت برجي التجارية العالمي في نيويورك والبنتاغون في واشنطن، وهي الهجمات التي أكدت كل الوقائع أن الاستخبارات الأميركية كان لديها إما إنذارا سبق قبل حصولها، أو تواطأت في السماح بحصول هذه الهجمات لاستخدامها غطاء لتبرير شن حربها لفرض هيمنتها على العالم وتحويل القرن الواحد والعشرين إلى قرن أميركي من خلال السيطرة على منابع وموارد الطاقة وطرق إمدادها، التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي، ومحاصرة الصين وروسيا وإيران ومنعهم من منافسة الولايات المتحدة، وبالتالي إخضاعهم لهيمنتها.
اليوم بعد أن فشلت أميركا في تحقيق هدفها من السيطرة على منابع وموارد الطاقة، وأخفقت في حربها في العراق وأفغانستان، ونتج عن ذلك تراجع الاقتصاد الاميركي، الذي عبر عنه بانفجار أزمة عام 2008، وتنامي قوة الصين التي تهدد الإمبراطورية الأميركية في إزاحتها عن التربع على عرش الاقتصاد العالمي باعتبارها الدولة الأولى والأقوى في العالم.
فالصين، تشير كل الوقائع والمعطيات إلى أنها تسير بخطى ثابتة صعوداً نحو احتلال المرتبة الأولى كأول دولة اقتصادية في العالم، بدلاً من الولايات المتحدة التي تزداد انحداراً يوما بعد يوم.
اليوم بدأت أميركا تمهد لمواجهة تنامي ما تسميه «خطر الصعود الصيني» الذي ينافس بقوة الاقتصاد الأميركي في الساحة الدولية، لاسيما في آسيا وإفريقيا، عبر اختراع نظرية جديدة في سياق ما تسميه صراعات الحضارات، لكن هذه المرة بين «الحضارة الغربية والحضارة الصينية».
هذه النظرية تحدثت عنها مجلة فورين أفيرز في مقال للكاتب غراهام أليسون يشير فيه بوضوح إلى «أن الأميركيين استيقظوا على وقع بزوغ نجم الصين قوة تقارع الولايات المتحدة على أصعدة عدة، وتماماً كما فعلت من قبل ألمانيا واليابان ودول أخرى شهدت تحولات شاملة وعميقة أبرزت ديمقراطيات ليبرالية متقدمة». غير أن ما يقلق أميركا بشكل أساسي أن يؤدي الصعود الصاروخي للصين إلى القمة إلى «عدم ذوبانها في نظام عالمي ليبرالي» كما توقع هنتنغتون في كتابه «صراع الحضارات» بل تشكيلها نظاماً اقتصادياً نقيضاً للنظام الرأسمالي الليبرالي، وهذا التناقض ينبع من عوامل عدة:
العامل الأول، طبيعة النظام الاقتصادي الصيني القائم على المزج بين الاشتراكية واقتصاد السوق الرأسمالي والهادف إلى تحقيق التنمية والتطور والتقدم الاقتصادي، الزراعي والصناعي والتكنولوجي وامتلاك المعرفة، وصولاً إلى تحقيق حلم الصين في بلوغ مجتمع رغيد الحياة لا يوجد فيه فقراء وقد تم ردم الهوة بين المدينة والريف، وأصبح مستوى المعيشة بالنسبة لجميع الصينيين في مستوى جيد. هذا المنظور الصيني للتطور الاقتصادي غايته الارتقاء بحياة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية على عكس النظام الرأسمالي القائم في الولايات المتحدة والذي تشكل غايته أولا وأخيرا تحقيق مصلحة الشركات الرأسمالية وزيادة أرباحها.
هذه المفارقة تزيد من قلق النظام الأميركي الذي ينظر إلى النموذج الاقتصادي الصيني باعتباره تهديداً كبيراً له كونه يقدم نموذجاً متقدماً يقوم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ينافس بقوة النموذج الرأسمالي، بمعنى إن ما فشل في تحقيقه النظام السوفياتي، يعمل على تحقيقه النظام الصيني الذي استفاد من أخطاء الاتحاد السوفياتي السابق وعمد إلى سلوك طريق جديد في تطبيق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والتي نجحت في توظيف والاستفادة من الاستثمارات الرأسمالية الغربية لتحقيق قفزات نوعية في المجالات الصناعية والزراعية والعلمية والتقنية في غضون ثلاثة عقود ونيف من العمل الحثيث والجاد، وفق خطط مدروسة بدقة وعناية حددت أهداف التنمية الاقتصادية، وهي سعادة الإنسان الصيني بالدرجة الأولى، وهذه السعادة لا يمكن بلوغها من دون تحقيق التقدم والتطور في المجالات كافة، ومعدلات نمو مرتفعة بشكل مستمر.
هذا التطور الصيني المضطر يساعد عليه روح الصينيين المستندة إلى العمل الجماعي الذي يحقق فيه الفرد أحلامه من خلال اسهامهم في تنمية مجتمعهم وبلدهم، أي أن تحقيق المصلحة الخاصة إنما يتم من خلال تحقيق المصلحة العامة.
في النموذج الاميركي القائم على الفردية تتقدم المصلحة الخاصة على مصلحة المجتمع، أو المصلحة العامة، كما أنه من الطبيعي أن نجد الفارق أيضاً في النظامين الاقتصاديين الصيني والأميركي من خلال الانعكاسات )الاجتماعية التي يحدثها كل منهما.