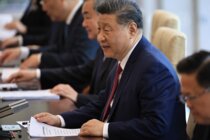في النقاش بشأن قانونية مرسوم «الأقدمية» الممنوحة لضباط دورة عام 1994، يُغفَل أمر قانوني شديد الأهمية، رغم كونه الأساس الذي يرتكز عليه المرسوم. قانون الدفاع الوطني (المرسوم الاشتراعي 102 الصادر عام 1983)، في المادة 47 منه، ينص على الآتي:
«يمكن منح الضابط أقدمية للترقية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين تقديراً لأعمال باهرة قام بها خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ الأمن أو اشتباك مسلح في الداخل». ولا بد من التذكير بأن «الأقدمية» تعني منح الضباط حق الترقية قبل موعد استحقاقها.
فإذا كان سيُرقى من الرتبة التي هو فيها حالياً، في بداية عام 2019، فستمكّنه «أقدمية» عام واحد من الترشح إلى الترقية في بداية عام 2018. ولطالما لفت ضباط ومسؤولون عسكريون وأمنيون إلى أن «الأقدمية» هي «أخطر مكافأة» تُمنح لضابط، لكونها تؤثر في التراتبية، وتجعل المرؤوس رئيساً. كذلك فإنهم يشيرون إلى أن القانون نفسه لم يوجب منحها لأحد، ولو قام بأعمال «باهرة»، بل جعلها اختيارية، لخطورتها. من هنا، لا بد من طرح سؤال يردّ المسألة إلى جذرها، غير السياسي: ما هي الأعمال الباهرة التي قام بها ضباط دورة عام 1994؟ وما هي هذه الأعمال الباهرة التي قاموا بها مجتمعين، بلا استثناء؟ وهل يستقيم منحهم هذه المكافأة الخطيرة، من دون الإفصاح عن الإنجازات التي حققوها؟ ليس طرح هذا السؤال من باب النكاية، وخاصة أن بعض هؤلاء الضباط حققوا فعلاً العديد من الأعمال التي يمكن وصفها بـ«الباهرة». يكفي أحدهم ما أنجزه في مجال الاستعلام التقني، وتطوير البرامج الموجودة في الفرع الذي يرأسه للقيام بقفزات نوعية ساهمت في تنفيذ عمليات أمنية استباقية جنّبت البلاد أعمالاً إرهابية. هذا الضابط، كما غيره من ضباط «دورة عون»، يستحقون المكافأة، ولو كانت من مستوى «الأقدمية». لكن ما الذي يبرر هذا «الإسراف» في «القِدَم الاستثنائي»؟ المدافعون عن المرسوم يتحدّثون عن دافع وحيد، هو «رفع الغبن» عن ضباط التحقوا بالمدرسة الحربية في ظل الحكومة العسكرية التي ترأسها العماد ميشال عون، ثم انقطعوا عن الدراسة بسبب الظروف التي أنتجتها «حرب التحرير»، قبل أن تستوعبهم دولة ما بعد الطائف، ويعودوا إلى المدرسة الحربية عام 1993 ليستكملوا دراستهم ويتخرجوا برتبة ملازم في نيسان 1994. و«رفعُ الغبن» يُقصد به تعويض الوقت الذي أهدروه، قسراً، خارج المدرسة الحربية. وبصرف النظر عن حقهم في «تصحيح أوضاعهم» أو عدمه، يبقى أن منحهم «قِدَماً استثنائياً للترقية»، بمرسوم عادي، هو أمر مخالف للقانون الذي يحدد بوضوح شروط هذه المكافأة. وفي دفاع أنصار المرسوم شيء من الاعتراف بهذا الخلل. أحد هؤلاء يقول إن العماد ميشال عون سعى إلى تسوية أوضاع الضباط من خلال محاولة إصدار قانون في مجلس النواب. لكن اقتراح القانون لم يبصر النور. وإحالته على اللجان النيابية كانت لوضعه في الأدراج. والدليل على ذلك أن اللجان لم تناقشه. لكن هل تسمح هذه الوقائع بإصدار هذا المرسوم السابقة؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست قانونية بالتأكيد، بل سياسية. وهي تتصل بتطويع القوانين والدستور، كرمى للتوازنات. والحديث عن التوازنات يعني حصراً، في لبنان، حصص «ممثلي الطوائف» وقدرتهم على التأثير في «النظام». وهو يعني أيضاً فتح الباب أمام تسويات تجعل «الجميع» يخرجون «رابحين».
ثمة أمر إضافي لا بد من الإشارة إليه. وجود ضباط دورة عام 1994، ووصولهم إلى المواقع التي يشغلونها اليوم، دليل على أن ما قام به العماد إميل لحود، والفريق الأمني لحكم ما بعد الطائف، كان فعلاً، لا قولاً وحسب، استيعاباً لجميع أبناء المؤسسة العسكرية، وإعادة رتق ما تمزّق في سنوات الحرب الأهلية. وبعيداً عن تقويم السياسة العامة لتلك الحقبة، فإن الإدارة السياسية لشؤون المؤسسة العسكرية، أدت إلى جعل الجيش بالصورة التي هي عليه اليوم، سواء لجهة التوازنات المحفوظة فيها، أو ابتعاده ــ قدر الإمكان ــ عن الخضات الطائفية والمذهبية التي ضربت البلاد بعد انسحاب الجيش السوري. ومن الجائز القول إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو أكثر العارفين بهذا الواقع، والحريص عليه. ومن هذا المنطلق تحديداً، كان الأجدى تجنيب المؤسسة خضة من النوع الذي سبّبه هذا المرسوم. وأداء قائد الجيش، العماد جوزف عون، في الأشهر التسعة الماضية، يُظهر أنه كان قادراً على معالجة هذه القضية بصورة مختلفة. فمن خاض معركة الجرود، وفتَح ملفات الفساد في المؤسسة، وأصرّ على تطبيق القانون بحذافيره في مباراة ترقية الرتباء إلى ملازمين، يملك ــ لا شك ــ ما يؤهله لحل هذه المعضلة، لو تُرِك له القرار ليُصدره «من تحت»، بدلاً من العجلة التي أصرّ عليها (مستشار رئيس الجهورية) العميد بول مطر «من فوق».