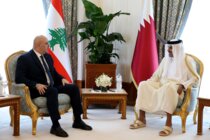تكشف الإتصالات والمشاورات الجارية في مختلف الإتجاهات خلال هذه المرحلة أنّ أهل السلطة يقودون إستنفاراً سياسياً بخلفية اقتصادية لتمكين رئيس الحكومة سعد الحريري من الذهاب الى لقائه مع الرئيس ايمانويل ماكرون الجمعة المقبل، والتأكيد له أنّ لبنان جدّي وينفّذ دفتر الشروط الذي طلبته مجموعة «الدول المانحة» على أمل أن يبادر ماكرون في ضوء ذلك الى تحرك تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر».
تنشغل السلطة في هذه المرحلة بمشروع قانون موازنة 2020 بغية إقراره ضمن المهلة الدستورية، اي قبل نهاية السنة الجارية، ولكنّ الآمال في ان تؤدي هذه الموازنة الى نقلة نوعية في الوضع المالي والاقتصادي للدولة تبدو ضعيفة، لأن قواعد العمل التي اعتمدت في موازنة السنة الجارية 2019 إعتمدت هي نفسها في موازنة 2020، بحيث إنّ أبواب الجباية المعوَّل عليها تبدو ضعيفة والوضع الاقتصادي في حال من التراجع، والمنطقة كلها مشلولة اقتصادياً نتيجة ما تشهده من احداث وتطورات عسكرية وسياسية وإقتصادية ومالية متلاحقة.
كذلك فإنّ «الخطوط الحمر» التي رُسمت في موازنة 2019 بقيت هي نفسها في موازنة 2020، وربما يكون هناك فارق في نسبة العجز التي بلغت 7,56 في المئة في 2019 بتيجة خفض ألف مليار ليرة في قطاع الكهرباء، لكن هذا الخفض لن يبقى على ما هو عليه في موازنة 2020 لأنّ العجز سيزيد عن ذلك بسبب ارتفاع خدمة الدين العام وتزايد المبالغ المالية التي تدفع رواتب وتعويضات للمتقاعدين، فهذان الأمران قد يذهبان بأكثر من نصف ما خفّض في الكهرباء انما لم يأتِ الأمر «راس براس».
ولذلك، يعتقد بعض الخبراء انّ امام اهل السلطة ستة اشهر حتى يثبتوا للدول المانحة والمقرضة أنهم «تلاميذ نجباء» يستوعبون ما يلقى عليهم وينفذون ما يُطلب منهم في بلد بات منزوع السيادة المالية والاقتصادية ما يعني أنه بات بنحو او آخر منزوع السيادة السياسية أيضاً، لأن مَن يقبل بانتهاك الآخرين، أيّاً كانوا، لوضعه المالي والاقتصادي يقبل تلقائياً وحكماً بانتهاكهم وضعه السياسي وسيادته.
ولعلّ السؤال الذي يطرحه كثير من السياسيين والمراقبين في الداخل والخارج هو كيف للطبقة السياسية اللبنانية التي تتحمل المسؤولية عمّا وصل اليه واقع البلد السياسي والاقتصادي والمالي أن ينزل عليها «وحي الإخلاص» بحيث تحترم المال العام الذي كان نهباً لها على مدى عشرات السنين، في الوقت الذي يبدو اللبنانيون انهم مجبورون على القبول بهذه الطبقة، على رغم كل ارتكاباتها واخطائها وخطاياها بحقهم وحق البلاد.
والى ذلك، يقول البعض إنّ لبنان الذي حقق في الآونة الاخيرة «إنجازاً وطنياً، تمثل في أنه واجه بموقف موحد الهجوم الاسرائيلي بالطائرتين المسيّرتين على الضاحية الجنوبية لبيروت، ثم برد «حزب الله» عليه بتدمير آلية اسرائيلية في مستعمرة أفيفيم وإسقاط طائرة مسيّرة على الحدود الجنوبية، هذا اللبنان بدا قبل أيام منبطحاً امام السياسة الاميركية في ظل وجود البارجة الحربية الاميركية في بحره وفي ذروة العقوبات التي تفرضها واشنطن على «حزب الله» وعلى مصارف واشخاص، وتنبري في الوقت نفسه الى شنّ «هجوم ايجابي» على الطبقة السياسية لتُظهر من خلاله انها تفصل بين سياق عقوباتها على الحزب وكل مَن تشتبه بمدّ يد العون له وبين الحزب نفسه، ما يعني انها تعمل لعزله سياسياً على رغم من إدراكها أن تخوض معركة خاسرة في هذا المجال. إلّا أنها مع ذلك تحاول مراكمة أوراق علّها تفيدها في اللاحق من التطورات، وربما من المفاوضات على المستويين اللبناني والإقليمي.
وفي خضم هذا الواقع يبرز الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، شخصية حيوية، إذ تبيّن لبعض مَن التقوه أنه «درس ملفاته جيداً»، وأنه يسعى في هذه المرحلة الانتقالية التي تنشغل فيها اسرائيل بانتخاباتها التشريعية، الى محاولة نسج حيوية معنيّة لشخصه آملاً في أداء أدوار اكبر في المرحلة المقبلة داخل الاميركية وفي المنطقة، ما يعني ان لا شيء قريباً على صعيد ترسيم الحدود، وقبلاً لا شيء قريباً على صعيد جلوس لبنان واسرائيل الى طاولة التفاوض برعاية شينكر في مقرّ قيادة القوات الدولية (اليونيفل) في الناقورة، وهذا المشروع هو نفسه الذي كان يعمل عليه الوسيط السابق ديفيد ساترفيلد.