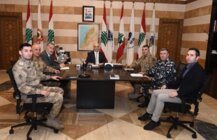تبدو اللعبة هي نفسها، بكل عناصرها. والبلد يواجه سيناريو تشرين الأول 2019. آنذاك، نفَّذت قوى السلطة مناورتها بنجاح، ونجت من السقوط. واليوم، هي تكرِّر المحاولة. فهل تنجح؟
لم يكن زلزال 4 آب حدثاً عادياً. وبمعزل عن خلفياته وملابساته وظروفه، هو أطلق الانتفاضة الثانية التي راهن كثيرون على أنّها ستكمل ما عجزت الانتفاضة الأولى عن تحقيقه.
لم يكن أحد يتوقع نزول الشعب إلى الشارع في 17 تشرين الأول، وإسقاط حكومة «الصفقة» بين الحريري و»حزب الله» وحلفائه والآخرين. لكن الصدمة حصلت.
واليوم، ربما توقَّع كثيرون حصول ضربات إسرائيلية أو مناوشات بين إسرائيل و»حزب الله» تقود إلى وقائع جديدة في لبنان، لكن أحداً لم يتوقع زلزالاً «غامضاً»، داخل المرفأ، وفي قلب بيروت.
صدمة تشرين أطلقت الغضب الشعبي ثم توقفت لأنّها وصلت إلى الحائط المسدود، أي إلى استحقاق الصدام المباشر مع قوى السلطة. وهذا يعني الوقوف على حافة الحرب الأهلية. لكن كثيرين راهنوا على أنّ الجوع الناتج من فشل حكومة دياب سيطلق انتفاضة عاتية تؤدي إلى إسقاط السلطة تلقائياً.
يعترف أركان الانتفاضة بأنّهم كانوا يتخبَّطون عاجزين عن توفير الظروف لإطلاق الموجة الثانية بالزخم الذي يفرض تغييراً حقيقياً على الأرض، خصوصاً أنّهم مختلفون على الوسائل والأهداف. وعندما وقع زلزال المرفأ تحرّكت المياه الراكدة، وتولَّدت معطيات جديدة، يعتقد البعض أنّها ربما تقود إلى تغيير.
في اختصار، يراهن هؤلاء على أنّ ما لم يفعله زلزال 17 تشرين سيفعله زلزال 4 آب. والقوى الدولية التي واكبت الانتفاضة الشعبية آنذاك، ولا سيما منها الولايات المتحدة وفرنسا، دخلت اليوم بقوة على خط انفجار المرفأ. والهدف هو نفسه: تغيير طاقم السلطة الذي يتحمّل المسؤولية.
ولكن هذا الطاقم يستخدم اليوم الأسلوب الذي نجح فيه بإطفاء انتفاضة الخريف، والقائم على مزيج مركَّب من التمييع والمراوغة من جهة، والمعاندة والتهديد من جهة أخرى. والاستعداد لـ»خردقة» الحراك من الداخل، عندما يصبح مزعجاً.
ولإدراك الخطة التي يتَّبعها اليوم طاقم السلطة، تَجدر العودة إلى خطته السابقة. فآنذاك، سارع الرئيس سعد الحريري إلى الاستقالة، بعد 10 أيام من انطلاق الانتفاضة، وبعد مسرحية «الورقة الإصلاحية». وبعد ذلك، امتنع رئيس الجمهورية ميشال عون عن الدعوة إلى استشارات التكليف قبل التوافق على اسم رئيس الحكومة وتشكيلتها وبرنامجها.
تعمَّد الطاقم السياسي تشكيل حكومة دياب من أسماء لا غبار عليها إجمالاً على المستوى المهني والشخصي، وأوحى بأنّها ستتجاوب مع مطالب الانتفاضة وشروط المجتمع الدولي وتُنفّذ الإصلاحات. لكنها عملياً حافظت على الفساد والفاسدين وتصادمت مع القوى والمؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي.
آنذاك، تراجعت الانتفاضة لمنح الحكومة فرصة طلبتها، مدّتها 100 يوم. ولكن، في الواقع، لم يكن يُراد من هذه الحكومة سوى ملء الوقت الضائع حتى تشرين الثاني، موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
اليوم، السيناريو إيّاه: دياب يفعل ما فعله الحريري، فيستقيل بعد 4 أيام من زلزال المرفأ، لتنفيس الضغط. وفيما يطالب الشارع والمجتمع الدولي بحكومة حيادية ونظيفة وفاعلة، جاء موقف الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله حاسماً: نريد حكومة وحدة وطنية، فيها تكنوقراط.
عملياً، حكومة كهذه ستكون تكراراً لحكومة دياب التي كانت القوى السياسية تحصي أنفاسَ وزرائها، سواء على طاولة مجلس الوزراء أو في وزاراتهم وإداراتهم وأجهزتهم. واعترافات هؤلاء الوزراء «الهامسة» و»الفاقعة» تكفي لشرح معاناتهم التي انتهت برغباتٍ عارمة في الاستقالة.
زلزال المرفأ قطع الوظيفة التي تؤديها حكومة دياب، أي إمرار الوقت حتى الخريف. لذلك، تتأرجح خيارات «حزب الله» وحلفائه بين 3 هي:
1 - العودة إلى نموذج الحكومة الحريرية. وهذا الخيار غير مرغوب فيه أميركياً وعربياً، لكن الفرنسيين ربما لا يمانعون في اعتماده.
2 - المجيء بـ»دياب آخر»، على رأس تركيبة مشابهة للتركيبة المستقيلة.
3 - إبقاء حكومة دياب في وضعية تصريف الأعمال، على الأقل حتى تبلور المناخ الجديد في البيت الأبيض.
وثمة مَن يرجّح الخيار الأخير، لأنّه الأقل كلفة ويواجَه بأقل مقدار من الاعتراض داخلياً وخارجياً. وفي العادة، تتعرّض حكومات تصريف الأعمال لمستوى أدنى من الضغوط الخارجية، لأنّها ليست في وضعيةٍ فاعلة وتسمح بمحاسبتها.
سيكون اعتماد أي من الخيارات الثلاثة مدمّراً، لأنّه سيعني وضع لبنان خارج أي برنامج اهتمام أو دعم دولي. وعلى العكس، سيُصنَّف على أنّه تكريس لالتحام لبنان بالمحور الإيراني. وسيكون التحدّي كبيراً في ظل النقطة البالغة السخونة التي وصل إليها النزاع الأميركي - الإيراني.
وسينجح «حزب الله» وشركاؤه إذا تراخت إدارة الرئيس دونالد ترامب في لبنان وانغمست في مواجهتها الكبرى مع إيران أو عقدت صفقة معها أو انشغلت في الانتخابات الرئاسية. وفي هذه الحال، سيكون هؤلاء قد مرَّروا المرحلة الصعبة اليوم كما فعلوا في تشرين.
ولكن، إذا كان جدّياً مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، ديفيد هيل، في قوله «انتهت اللعبة»، فإنّ مسار الأزمة في صيف 2020 لن يكون كما في خريف 2019.
يبقى عامل آخر هو الموقف الفرنسي. فالأوروبيون عموماً لم يتماسكوا مع واشنطن في مواجهة إيران. لكن موقف باريس بدا أخيراً أكثر تماسكاً مع واشنطن. ولطالما اعتمدت إيران على الأوروبيين لتمييع الضغوط الأميركية. وبعد فشل الأميركيين في تمديد حظر التسلّح الإيراني، في مجلس الأمن، سيكون الأوروبيون أمام التحدّي.
ويقول البعض، إنّ الإيرانيين يعرفون كيف يتدبرون التعاطي مع فرنسا والأوربيين عموماً، وما يهمّهم هو تنفيس الضغط الأميركي مرة أخرى. وإذا اقتضى الأمر، فلتبقَ حكومة التصريف إلى أجَلٍ غير مسمّى. وليتعب الأميركيون ويرحل ترامب. كلها مسألة شهرين أو ثلاثة!