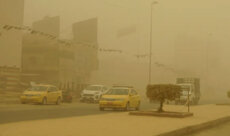«بمَ التّعَلّلُ لا أهْلٌ وَلا وَطَنُ
وَلا نَديمٌ وَلا كأسٌ وَلا سَكَنُ
أُريدُ مِنْ زَمَني ذا أنْ يُبَلّغَني
مَا لَيسَ يبْلُغُهُ من نَفسِهِ الزّمَنُ
كمْ قد قُتِلتُ وكم قد متُّ عندَكُمُ
ثمّ انتَفَضْتُ فزالَ القَبرُ وَالكَفَنُ
قد كانَ شاهَدَ دَفني قَبلَ قولهِمِ
جَماعَةٌ ثمّ ماتُوا قبلَ مَن دَفَنوا
مَا كلُّ ما يَتَمَنّى المَرْءُ يُدْرِكُهُ
تجرِي الرّياحُ بمَا لا تَشتَهي السّفُن»
(المتنبي)
كلما ردّدت شعر المتنبي أشعر فيه يعيش اليوم بيننا، فالشعر البليغ لا عمر له ولا زمن، فهو التسامي فوق المكان والزمان. وكأنني أرى ذاك المغرور العبقري الانتهازي المبدع، يستهزئ بالسهام التي قتلته ولم تنل منه، وها هو يحيا بعد ألف عام كلما ذُكر إسمه. لكن لو تمعّنا بالبيت الأول، بمَ التعلّل لا أهلٌ ولا وطنٌ، فسنرى اللبنانيين اليوم ينشدون الكلام بمرارة أيامهم على درب الجلجلة الطويل، وحتى النديم والكأس حُرموا منهما بسبب الحَجر، والسكن طار ومعه جنى العمر. لا أحد ينتظر اليوم خبراً سعيداً، بل اللطف في المكروه. لكن، كم قتل الدهر هذا البلد وكم نكّل بأهله، ثم انتفضوا على القبر ومزّقوا الأكفان، وبما أنّ الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، فما علينا إلاّ إعداد البدائل، من خلال فهم ما هو ممكن، وتقريبه مما نرتجي.
لا شك في أنّ كثيرين من النِخَب والمواطنين الذين نزلوا على مدى الأشهر العشرة الماضية إلى شوارعهم، بهدف رفع رايات النصر نهائياً عليها، وإزالة صور ونُصُب الآلهة الكاذبة عن العواميد والحيطان، مصابون اليوم بخيبة أمل، خصوصاً بعد أن أتت المبادرة الفرنسية بأقل كثير من المرتجى، وربما يشعر البعض أنّها عكس آمالهم بكاملها. لكن بالعودة إلى ما هو ممكن، وعلى رغم من أنني لم أعتقد يوماً أنّ الدول هي جمعيات خيرية، لكن تقاطع المصالح قد يكون الوسيلة الأكثر أماناً للحلول. يعني إن تقاطعت مصالح فرنسا الاستراتيجية اليوم مع ما يصلح الحال، أو حتى يوقف الإنهيار في لبنان، فأظن أنّ هذا الوضع أكثر مدعاة للثقة من مجرد انتفاضة انسانية دعت إيمانويل مكرون الى التجول في الشوارع المنكوبة.
لكن المبادرات إن حاولت أن تجد لها منفذاً، فعليها أن تبني على الواقع في العالم، وليس في عالم المثل الأفلاطوني. وعالم المثل هو كان دائماً شعار الثورة في كل مكان، إي تدمير الواقع بكامله، والتسامي فوقه إلى بناء عالم المثل مكانه.
واقع لبنان وموازين القوى والتعقيدات المتعدّدة الوجوه تعرفه فرنسا، وأحياناً أكثر بكثير من الثائرين والحاكمين على حد سواء. قبل السعي لتغيير كل شيء، كان المنطق بالابتداء بوقف الانهيار السريع في الدولة، وما كارثة المرفأ ومأساته إلّا مؤشراً على الواقع، حتى ولو لم تحدث، فإنّ فشل الدولة أصبح واضحاً في كل مفصل من مفاصلها. فلا أمن ولا اقتصاد ولا صحة ولا مال ولا مستقبل ولا سيادة، ومعها كل ما هو عدم بكل أشكاله. ولكن، وحتى نكون منصفين، فإنّ الثورة بكل شعاراتها وآمالها، بقيت محشورة في زاوية واقع كوننا لبنانيين. فالكل يرى في نفسه مؤهّلاً ليكون رئيساً ووزيراً ونائباً ومقاولاً وضابطاً... وكلنا نحمل إلى مدنيتنا المفرطة في التطلع إلى المستقبل، تاريخانية البداوة والتماهي بالقبلية والعشائرية، وبالتأكيد بالشخصانية.
علينا أن نعترف أنّ الثورة رفعت شعارات ولم تحمل مشروعاً، ورفعت هتافات عامة ولم تتمكن من تحديد مكامن العلل كلها، وأعلنت نفسها بريئة من دم الصدّيق، لكن من كان منهم يحمل الخطيئة تجرأ ورمى الحجر على غيره ولم يحاسب نفسه. في المحصلة، فإنّ الثورة وإن هزّت المؤسسة، لكنها لم تقنع أحداً أنّها البديل الواقعي. لم نسمع بأي مشروع متماسك، ولا حتى بقيادة متوافق عليها، واختصرت الشعارات بالرفض، «كلن يعني كلن»، ولم نفهم ما هو المقبول. لكن وراء تعميم الرفض كان نوع من الجبن في تحديد ما هو مرفوض، ومع تلاشي الأمل بتحفيز كل الطوائف على المشاركة في الثورة، بقي مبدأ تجهيل الفاعل هو السائد، بالأخصّ عندما تأتي الأمور إلى مسألة السيادة الوطنية وخرق الميليشيا المسلحة لها، وهو فساد في حدّ ذاته.
عندما أتى ماكرون، أتى وهو يرى الحل الممكن من خلال ما هو واقعي. فحتى ولو سلّمنا جدلاً أنّ نصف اللبنانيين هم مع الثورة، فإنّ هذه الثورة لم تفرز من يفاوض عنها ويطرح مطالبها في مشروع ولو غير مكتمل. فإن طرحنا قانون انتخابات، لأتت عشرات العناوين من دون تفاصيل، وإن طرحنا مسألة محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، لأتانا الآلاف من الأسماء والآرقام الآتية من عالم الغيب من دون توثيق. وإن أتينا إلى مشاريع اللامركزية الإدارية، فسنرى العجب بمن يراها مجرد وسائل للتخلّص من الآخر المختلف ليس إلّا. ولو ذهبنا إلى أسباب تدهور اقتصادنا، لتوزعت الآراء يميناً وشمالاً، ولتحول كل منا محللاً اقتصادياً، ويكفي الشعار الفارغ اليوم باتهام السياسات الاقتصادية السابقة، من دون تحليل ما عطّل وتسبّب بتدمير هذه السياسات. هذا بكل بساطة طبيعي، فليس كل البشر لديهم الصبر لفهم التفاصيل في شكل تحليلي، فيأتي الشعار المنمق ليحلّ مكان الواقع المعقّد.
وبالعودة إلى الواقع، ورغم كل الشوائب التي تحوط بما يحصل، ورغم أنّ ملامح المستقبل لا تزال مشوبة بالغموض، ما يدفعنا إلى الحذر من التفاؤل، لكن المبادرة الفرنسية هي ما هو حاضر في اليد الآن. وسيكون لنا مجلس إدارة لها قد يتمكن من صنع العجائب، إن أتت الرياح بما تشتهي السفن، أو أن نحصل على فرصة بضعة أشهر من الأمل ومن وقف التدهور، أو تأخيره على الأقل.
هناك حكومة آتية، وعليها أن تأتي بسرعة لإدارة المبادرة حتى لا يسبقنا الوقت وتأتي الاستحقاقات المقبلة ونحن في عالم النسيان. وقف الانهيار المالي مرهون اليوم بمساعدة صندوق النقد الدولي، وملف الكهرباء هو الأولوية للوصول إلى نتيجة في التفاوض. يأتي بعدها ملف المرفأ والمطار وما هو سائب فيهما من المال العام، وقد يُفرج هذا أيضاً عن مقررات «سيدر». الملف العالق حتى هذه اللحظة مرتبط بتطبيق القرار 1701 وما هو متعلق بالحدود البرية، وأظن أنّ هذه النقطة عقدة صعبة في هذه اللحظة، وعلينا مراقبة ما سيحدث في قضية التجديد لقوات حفظ السلام في الجنوب لنفهم كيف ستتجّه الأمور. أما عن الانتخابات المبكّرة أو المؤتمر الوطني، أو التأسيسي، أو أي تسوية ما تصيب طبيعة النظام، فسيكون عنها حديث لاحق في مقالة أخرى.