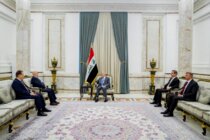كثُر الحديث في الداخل اللبناني في الآونة الأخيرة عن "عقدٍ سياسيّ جديد" بات النقاش حوله "حتميّاً" في ضوء الأزمات الوجوديّة المتراكمة التي يتخبّط اللبنانيّون خلفها، من دون أن تلوح في الأفق أيّ "بشائر" انفراج قريب، أو ممكن بالحدّ الأدنى.
ومع أنّ مثل هذا الحديث قد لا يكون الأول من نوعه، فإنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو من نجح في "إحيائه" خلال زيارته الأولى للبنان، بعيد انفجار الرابع من آب، والتي استهلّها بالحديث صراحةً ومن دون مواربة عن وجوب "تغيير النظام".
لكنّ "المفاجأة" تمثّلت في إبداء معظم الفرقاء "انفتاحهم" على الطرح الفرنسيّ، بعدما كان من "المحظورات" طيلة السنوات الفائتة، حين كان يتمّ "رجم" من "يجرؤ" على التفوّه بعبارة "تغيير النظام"، أو ما يمتّ إليها بصلةٍ، قريبة كانت أم بعيدة.
ولعلّ "المفارقة" الأكثر إثارةً للجدل تمثّلت في ذهاب بعض هؤلاء أبعد من ذلك، عبر "المزايدة" على الرئيس الفرنسيّ نفسه، بطرح أوراقٍ ورؤى تشترك في تغليب الطابع "المدني"، من دون أن يحدّوا في الوقت نفسه من ممارساتهم "الطائفية" المتوارثة...
لا نقاش!
يرى البعض أنّ الرئيس الفرنسي استطاع في زيارتيه الأخيرتين إلى لبنان، ضرب أكثر من عصفورٍ بحجر النظام، وهو إن نجح في تحقيق أمرٍ ما، فقد يكون "إنعاش" فكرة المؤتمر التأسيسي التي طُرِحت قبل سنوات، قبل أن "تلفظها" الأحزاب نفسها، التي أبدت كلّ "انفتاح" على طرح ماكرون، ربما لأنّ كلّ ما يأتي من "الأجنبي" يجب أن يلقى التصفيق.
ويذكر اللبنانيون جيّداً أنّ الفكرة سبق أن وُضِعت على الطاولة، وقد كرّس لها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أحد خطاباته، يوم دعا إلى ما أسماه "تطوير النظام"، بعدما ثبُت بالملموس أنّه يعاني من ثغراتٍ بالجملة. لكنّ الرجل عاد و"تنصّل" من الفكرة من الأساس، بعدما اصطدمت بـ"فيتوات" بالجملة، تناوب عليها حلفاؤه وخصومه على حدّ سواء، ووصلت إلى حدّ الحديث عن "أجندة" خلفها، لفرض "المثالثة" أو ما يشبهها.
لكنّ طيّ صفحة "المؤتمر التأسيسي" قبل سنوات، وإعادة فتحها اليوم، ولو ظاهرياً، على وقع دعوات الرئيس الفرنسي، لا يعني أنّ ثمّة نقاشاً فعلياً بـ"صلاحيّة" النظام الحاليّ في لبنان، أو قدرته على "الصمود"، لأنّ الجميع مقتنعٌ بأنّ هذا النظام ليس مثالياً، بل إنّه "يترنّح"، ولو أنّ البعض يحاول "الهروب" من هذا الواقع عبر الإيحاء بأنّ المشكلة ليست في النصوص بل في النفوس، وبالدرجة الأولى في عدم تطبيق "الطائف" بحرفيّته حتى يومنا هذا.
ولا تُعَدّ "الدلائل" على "عدم مثالية" النظام ولا تُحصى، وهي تقترن بمختلف الاستحقاقات، وما ينجم عنها من خلافات واجتهادات دستورية وقانونية، كما يحصل اليوم مثلاً على هامش حقيبة "المال"، وما يُحكى عن "أعراف" على خطّها، ولو افتقدت أيّ أساسٍ دستوري، تماماً كما حصل قبل تكليف رئيس الحكومة، بالحديث عن "مصادرة صلاحيات"، وتماماً كما يحدث بعد كلّ تأليف حين يُفتَح النقاش حول "المهلة الأزليّة" التي تُمنَح لرئيس الحكومة، والذي يستطيع أن يبقى في منصبه إلى الأبد، من دون إنجاز مهمّته.
"أضغاث أحلام"
لا نقاش إذاً في أنّ "علّة" النظام منه وفيه، وبأنّ "تغييره"، أو ربما "تطويره" كما يحلو للبعض أن يقول، في محاولة للتقليل من وقع التعبير، ينبغي أن يكون "الخطوة الأولى" من مسار الإنقاذ الطويل، لكن لا نقاش أيضاً في أنّ "الإرادة" لمثل هذا التغيير ليست متوافرة لدى أحدٍ من السياسيين الذين "يَدينون" للنظام بـ"جَميل" تغذية نفوذهم وسيطرتهم، وهو ما ليس لدى أيٍّ منهم الاستعداد للتفريط به، ولو أكثروا من الكلام المُناقض.
يكفي للدلالة على ذلك، أن يشترط الأمين العام لـ"حزب الله" مثلاً "إجماع ورضى مختلف الفئات" للانخراط في أيّ نقاش من هذا النوع، معطوفاً على ما يُثار عن "هواجس ومخاوف" طائفية ومذهبيّة كلما أثير الملفّ، وكأنّه "استهدافٌ" لطائفةٍ معيّنة ولدورها. فحتى لو أنّ مثل هذا الشرط قد يبدو للوهلة الأولى "بسيطاً وبديهياً"، إلا أيّ مراقبٍ للشأن اللبناني وعارفٍ بدهاليزه، يدرك أنّه في العمق "تعجيزيّ"، خصوصاً أنّه يتطلّب موافقة المستفيدين من النظام الطائفي على إلغاء "امتيازاتهم" بكبسة زرّ، وهم الذين يعجزون عن إقرار مجرّد قانون انتخابي عصري بالحدّ الأدنى، ويصرّون على "تفصيله" على قياسهم.
أكثر من ذلك، يكفي للدلالة على ذلك المقارنة بين "أقوال الليل وأفعال النهار" لبعض "الزعماء" لإدراك "استحالة" الذهاب إلى أيّ تغييرٍ، ولو ضمنيّ، للنظام. ثمّة بين هؤلاء مثلاً من يدعو جهاراً إلى الدولة المدنيّة، ويفتعل مشكلةً طويلةً عريضة، لا على طائفة وزيرٍ من هنا، وحصرية حقيبة للطائفة، بل على "مذهب" أصغر موظّف يفترض تعيينه. وثمّة أيضاً بينهم من يدعو ليلاً نهاراً إلى المدنية، بل إلى العلمانية، لكنه عند أول مفترق، يبدي جهوزية لتعطيل البلاد بالكامل، من أجل "حقوق الطائفة".
صحيحٌ أنّ "الدولة المدنية" كما ينظّر البعض، لا تعني "إلغاء" للطائفة، لكنّ ذلك محصور بالممارسات الدينية، التي تبقى حقاً مشروعاً ومكتسباً للجميع، ولا يشمل الممارسات "الطائفية" التي باتت "علّة العِلَل" في نظامٍ قد تكون مصيبته الكبرى أنّه يغذّيها، تماماً كما قوّى نفوذ "أمراء الحرب" الذين باتوا، بفضله، "الحاكمين بأمرهم"، والمتحكّمين بأمر البلاد والعباد، والجاهزين لإعلان "الحرب" على أيّ بحثٍ جدّي بالتغيير، وصولاً إلى حدّ "تخوين" كلّ من يفكّر به، في "تحالفٍ" عابرٍ لكلّ الطوائف والأحزاب.
"خدعة وأكثر"!
هلّل كثيرون في الأسابيع الماضية للحديث عن "عقدٍ سياسيّ جديد"، ولما صُوّر وكأنّه ملاقاةٌ من مختلف الأفرقاء للرئيس الفرنسي في منتصف الطريق. وقد يكون هؤلاء على حقّ، لأنّ الطائفية هي أساس البلاء، ولأنّ محاربتها ينبغي أن تكون "واجباً وطنياً" يتخطّى كل ما عداه.
لكن سرعان ما تبيّن "زيف" الادّعاء، وحقيقة "الخدعة" التي لا يبدو أنّها ستنطلي على أحد. يكفي مسار تأليف الحكومة لـ"فضح" ذلك، بين من "انتفض" منعاً لـ"مصادرة" الرئيس "المسيحيّ" لحقوق رئيس الحكومة "السنّي"، ومن "تصدّى" للدفاع عن صلاحيات الأخير بتأليف الحكومة بمفرده، ومن "نبش" في أوراق التاريخ غير المكتوب، ليصرّ على أنّ وزارة المال لـ"الشيعة"، وليس لأحدٍ غيرهم.
لعلّ ايّ قارئ لمثل هذه العبارات "الطائفية" ينفر تلقائياً، "نفورٌ" بات واجباً على اللبنانيّين أن يشعروا به تجاه أنفسهم وتجاه نظامهم، بعيداً عن النوم على أطلال "أضغاث الأحلام" التي يغذيها الكلام "الجميل" الذي يتفوّه فيه بعض قادتهم، وهم يضحكون في سرّهم...