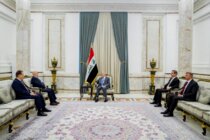عشيّة ذكرى 11 شهرًا على انفجار مرفأ بيروت المروّع، ومع بدء العدّ العكسي للذكرى السنويّة الأولى للجريمة الآثمة، أو "المجزرة الدمويّة" كما يفضّل كثيرون تسميتها، أطلق المحقّق العدلي الثاني في الجريمة القاضي طارق البيطار مسارًا قانونيًا جديدًا، من خلال طلبه أذونات لاستجواب عدد من كبار المسؤولين، على المستويين السياسيّ والأمنيّ.
هلّل كثيرون لإجراءات القاضي البيطار، ربما لأنّها شكّلت "خرقًا" يُبنى عليه، بعدما بدا الملفّ على مدى أشهر "منسيًّا" شأنه شأن معظم القضايا المحوريّة والجوهريّة في هذا البلد، ورأى فيها البعض "انتصارًا" للعدالة، متمنّيًا أن تفضي، ولو لمرّة واحدة، إلى رؤية بعض القادة الفاسدين والمُهمِلين، داخل السجون وخلف الزنازين.
في المقابل، ثمّة من أصرّ على وضع خطوات القاضي البيطار في سياقها، فهي ليست سوى "خطوة أولى" في مسارٍ قد يكون طويلاً، خصوصًا إذا ما بقي أسير "المماطلة"، علمًا أنّ هناك من قارن بين المسار الذي أطلقه البيطار، وذلك الذي سبقه إليه "سلفه" القاضي فادي صوان، الذي كان يعتزم أيضًا التحقيق مع بعض الأسماء التي ورد اسمها في "لائحة" القاضي الجديد.
فهل حصل القاضي البيطار على "ضمانات" تتيح له المضيّ إلى الأمام في خطواته، وبالتالي ينجح حيث "عجز" القاضي صوان، ولم يفشل، مع ما يعنيه ذلك من "تجاوز" القيود والضغوط السياسية التي "كبّلت" سلفه، أم أنّ "السيناريو" نفسه الذي أطاح بصوان، سيتكرّر معه، لتبقى "العدالة" المنشودة لضحايا الرابع من آب "في مهبّ الريح"؟.
اختلاف في "التكتيك"
من الناحية القانونيّة، ثمّة من يسجّل اختلافًا نوعيًا في "التكتيك" بين القاضيين صوان والبيطار، رغم التقارب الشديد بينهما في "خلاصات" التحقيق، والذي دلّت عليه لائحة الأسماء والشخصيات التي يعتزم المحقّق العدلي استجوابها، والتي تتشابه إلى حدّ بعيد مع تلك التي أراد صوان الادّعاء عليها، فأخرِج من المعادلة بسبب ذلك.
لعلّ السّمة الأساسيّة لهذا الاختلاف تتمثّل بـ"أسلوب" القاضي البيطار، الذي يبدو أنّه أخذ "العِبَر" من تجربة "سلفه"، والانتقادات التي وُجّهت له، فابتعد مثلاً في أول الطريق عن "الشعبوية" التي يُتَّهم صوان باللجوء إليها وفق مبدأ "ما يطلبه الجمهور"، وهو ما دفعه إلى إخلاء سبيل الكثير من "صغار الموظّفين" الذين تمسّك "سلفه" بتوقيفهم، رغم ظهور "أدلّة" على أنّهم إما لم يكونوا على علم، أو أنّهم تصرّفوا فعلاً وفق صلاحيّاتهم "المحدودة".
وانعكس الاختلاف في "التكتيك" أيضًا على طريقة تعامل القاضي البيطار مع الشخصيات التي يعتزم استجوابها، حيث استند بالمُطلَق إلى القانون، طالبًا "الأذونات" حيث يلزم، و"رفع الحصانات" حيث يجب، مبتعدًا بذلك عن بعض "الاجتهادات" التي روّج لها البعض سابقًا، عن غياب أيّ "موجبات" لمثل هذه الخطوة، وهو ما توّجه صوان برسالته الشهيرة إلى مجلس النواب، والتي خلقت "صدامًا" بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقد يكون هذا الاختلاف هو ما "أحرج" كثيرين، ودفع النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر مثلاً، إلى إصدار بيان "فوريّ" يعلنان فيه "استعدادهما للمثول فورًا" أمام القاضي، بصفة "شاهدَين" من دون انتظار "الإذن"، ولو أنّ البعض يضع كلّ ما يُحكى في هذا السياق في الإطار "الشعبويّ"، لأنّ المِحَكّ الحقيقيّ يبقى في الموقف النهائيّ، علمًا أنّ زعيتر وحسن خليل كانا أساسًا خلف "الإطاحة" بالقاضي صوان، لأنّه "تجرّأ" على طلب استجوابهما.
هل من "ضمانات"؟
في الشكل، يبدو إذًا أنّ ما يتوفّر للقاضي البيطار مختلف عمّا توافر للقاضي صوان، وهو ما يستند برأي كثيرين إلى أنّ السياسيّين "مُحرَجون"، وهم غير قادرين على الظهور بمظهر "المعرقِل" لسير التحقيقات في جريمة كبرى، بات واضحًا أنّ "إهمال" بعض المسؤولين، بالحدّ الأدنى، لعب دورًا جوهريًا في حصولها، وعدم تفاديها.
لكنّ الأهمّ من الشكل يبقى "المضمون"، فأيّ "ضمانات" يمتلكها القاضي البيطار حتى يمضي إلى الأمام في المسار الذي ارتضاه لنفسه؟ وماذا لو أوقعه السياسيون في فخّ "المماطلة" التي يتقنون "فنونها"، خصوصًا مع ما أثير عن فتح "معركة" الحصانات والأذونات التي قد لا تكون "ميسَّرة ومسهَّلة" بعكس ما يفترض في مثل هذه الأحوال؟ وماذا لو صحّت "الاجتهادات" التي بدأت بالانتشار عن إمكانية سحب الملف من يد القاضي، من باب تحقيقه مع "قضاة"؟.
ومن علامات الاستفهام "المشروعة" التي تُطرَح أيضًا، سؤال عن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي "استنفر" سابقًا رفضًا لأيّ استجواب له من قبل القاضي صوان، ووقف رؤساء الحكومات السابقين إلى جانبه، غامزين من قناة "استثناء" رئيس الجمهورية، لتُضاف القضية إلى سلسلة الملفات التي تتحكّم بها بدعة "ستة وستة مكرّر"، مع ما يكرّسه ذلك من "مظلوميّة طائفيّة"، تجدي شعبيًا، أو ربما شعبويّا.
لكلّ هذه الأسباب، قد يكون وقت "الاحتفاء" بخطوات البيطار سابقًا كثيرًا لأوانه، فما حصل لا يُعَدّ تقدّمًا ولا انتصارًا، بل مجرّد خطوة لا بدّ منها في مسار طويل، مسار لا شكّ أنّه مليء بالألغام والأشواك، مسار قد لا يفضي إلى أيّ مكان، سوى في حالة واحدة، وهي أن يترجم السياسيون أفعالهم إلى أقوال، فيُسقِطون كلّ الحصانات بلا استثناء، بمُعزَلٍ عن كلّ الأسماء التي يمكن أن يطالها التحقيق، أمرٌ يبقى مُستبعَدًا حتى إثبات العكس.
"مُدانون حتى يثبت العكس"!
في المبدأ القانونيّ العام، فإنّ المتهَم "بريء حتى تثبت إدانته"، لكنّ هذه القاعدة تصبح "مقلوبة" مع السياسيّين في لبنان، وإزاء جريمة بحجم انفجار المرفأ، لتصبح أنّ كلّ المتّهَمين، وحتى إذا لم تصدر مذكرات اتهامية بحقهم، "مُدانون حتى يثبت العكس".
لا يبدو ذلك غريبًا، فهؤلاء القادة السياسيون الذين اعترف بعضهم بأنّهم "كانوا يعلمون" بوجود نيترات الأمونيوم المخزّنة في مرفأ بيروت، قصّروا وأهملوا، ربما لـ"سوء تقدير"، وربما لغاياتٍ أكبر، تتّصل اتصالاً وثيقة بمنظومة "الفساد" التي يحمونها.
وحتى من لم يعلموا، أو بالحدّ الأدنى لم يثبُت أنّهم كانوا "يعلمون"، فقد يكونون "مُدانين"، طالما أنّهم "يصطفّون" حتى الرمق الأخير مع "شركائهم"، حلفاء أو خصومًا، ويعرقلون سير التحقيقات، ويضعون العصيّ في الدواليب.
القادة السياسيّون مُدانون حتى يثبت العكس، كيف لا، ومهلة الأيام الخمسة التي وُضعت لإنجاز التحقيقات أصبحت 11 شهرًا، دون تحقيق أيّ تقدّم، بل إنّ كلّ المؤشرات توحي أنّهم يراهنون على أن تمرّ القضية كما مرّت الكثير من "الجرائم" قبلها.
يقول ذوو الضحايا إنّ القضية لن تُغلَق، وإنّهم لن يسكتوا قبل أن تتمّ المحاسبة، محاسبة لن تعيد لهم أحبّاءهم، ولن تعيد لبيروت وهجها، ولن تعيد للبنانيين "سكونهم"، وقد لا تكون "فشّة خلق" حتى، لكنّها وحدها قد تسمح للحياة أن تستمرّ، في بلدٍ فَقَد كلّ مقوّمات العيش الكريم والآمن!.