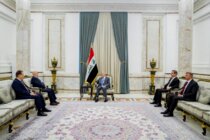في دردشة مع مجموعة من بلدتي، حول ما أكتبه منذ فترة، عبر مواقع إلكترونية، عبّرت إحدى السيدات عن تفهمها العميق له، قائلة: إن القلم يعبّر أحيانًا كثيرة عن الألم، ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود. وهذا القول هو مثل، لمن ينصح اناسًا وهم لا يعيرونه اهتمامهم، ولا يفهمون معاني الحِكَم والنصائح المقدمة لهم. ولا يستفيدون من الكلام والنصح الموجّه لهم. للأسف، كثر في أيامنا ينطبق عليهم هذا الكلام. ولم يعد يهمهم سوى مصالحهم الشخصيّة، ومنافعهم الذاتيّة، وينطبق عليهم قول الإنجيل: "أَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ الإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ الْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ"؟(مر 8: 36).
استفضنا بالحديث حول أهمية الكلام، والكتابة والتعبير عن وجعنا، وامتعاضنا من الأوضاع المزرية، في زمن بات فيه المسؤول مخدّرًا ولا يهمّه سوى مصالحه الشخصية والمناكفات الداخلية، وتنفيذ أجندة خارجية، وتوريث زعامته، وإيلاء شأن طائفته على حساب باقي المواطنين. وما ينطبق على المسؤولين في الوطن، ينطبق على كثر من المواطنين، على كافة الصعد والمستويات.
الحديث طال، ولم تقنعني في التوقف عن الكتابة لتاريخه، ولم أستطع أن أقنعها بنتائج آتية منها.
بعد أن افترقنا، وأدخلت فيّ الشك، بدأت استعرض جملة من المقالات التي دونتها، تحت عناوين متعددة، طالت مجالات عدة، وكنت أفكر إن كانت حبرًا على ورق، أو أنها أصابت في مواقع عديدة، واستطاع القلم أن يعبّر عن ألم ألوف من الناس، الذين لم تخرج من فمهم الكلمات، لأسباب وأسباب.
في لحظات الندم التي شعرت بها عن كل كلمة دونتها، تذكّرت كلامًا للمطران جورج خضر في إحدى مقالاته في صحيفة "النهار"، والتي حملت عنوان: "لماذا أكتب" حيث ورد في متن المقال: "أنا المؤمن أكتب لأن الله فوّض اليّ ذلك، لأنه يكلّم كلّ الناس ببعض من الناس. أنا لا استطيع أن أحتفظ لنفسي بما أخذته منه. “بلغ، إنك مبلغ”. فالوحي للناس والرسول رسول اليهم. أنت كلمة الله تحضنها وتعطيها. وما استودع رسول كلمة لنفسه".
أنا لا أدّعي الرسولية، ولا أتباهى بما أكتب، إنما أعبّر عن مشاعر وحقائق ووقائع، أرصفها أحرفًا، وأخطّها أحيانًا بدموعٍ كثيرة، بسبب الألم الذي أعيشه، ويعيشه المواطن في بلدي. كما أحرص على أن يطّلع على مقالاتي أحبّة، لديهم من العلم والمعرفة والخبرة، الشيء الكثير، قبل نشرها، لما أشعر من مسؤولية تجاه الله، وتجاه القارئ.
إن كان القلم فشّة خلق، فليكن، لما لا. أنا لا أستطيع أن أحجز كلمات، تمشي في عروقي وعقلي وكياني، وتجرح مشاعري، ولا أترجمها أحرفًا ونقاطًا وكلمات. فإذا كانت الكتابة وسيلة لأترجم ما يدور في فكري، لأشفي غليلي، فالقلم عندها، لا يعود قادرًا على ترجمة الأفكار لكلمات.
عزيزي القارئ، ليس من كلمة تخرج من فم إنسان تصيب مقصدًا، إلا وكان الله مُلهمها. ومن أنصت إلى الكلام، وحرّك مشاعره، فإن الله فاعلٌ فيه. لذلك أنا لا أكتب للذين سكن الشر عقولهم، إنما الذين آمنوا أن الله مخلصهم. أنا لا أكتب لأمتدح، إنما أكتب لإيصال رسائل هادفة بالقدر الممكن، علَّ وعسى، يومًا ما، تُحرك الكلمات القلوب المتحجرة، والعقول الصنميّة في بلادي. فأنا أنحني وأحترم للمنتقد إيجابًا، ولا أعير اهتمامًا للمادح سلبًا.
وهنا أذكر يومًا أن أحد السياسيين، الذين لتاريخه أحترمهم وأقدّر دورهم، عند قراءته لإحدى المقالات، بعث لي برسالة نصّية عبر الهاتف، متأثرًا بمضمونها، وقائلًا: إنه سيرسلها إلى زملاء كثر، وقد أتت يومها تحت عنوان: "الغيرة والحسد".
لكنّ المشكلة في الأشخاص الذين يتعلّلون بعلل الخطايا، ويرمون أي كلام نكتبه في وجه الآخرين، دون أن يكونوا تحت الكلمات.
فلندع السياسيين جانبًا، وهم الذين قَصدتهم تلك السيدة، في بداية المقال، ولنتوجّه إلى الذين تأثروا بما نكتب. فإن كانت النسبة ضئيلة، فهذا حافزٌ للإستمرار، وإن كانت معدومة، فالأجدر أن نتوقف عن الكتابة، وبالتالي أعيش الألم وحيدًا.
إلا أن التعليقات والمناقشات التي تستتبع مقالًا ما، وبتجرّد ومن دون مبالغة أو تشبَث في الرأي، سواء بشكل سلبي أو إيجابي من الكاتب أم من القارئ، تحفّزني لتاريخه، ترجمة الأفكار بكلمات في سطور، علَّ هذه الفئة الضئيلة تزداد يومًا بعد يوم، وهكذا نستطيع أن نغيّر ونتغيّر.