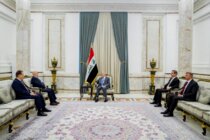الإنهيار الإقتصادي والمالي الذي ضرب لبنان بقُوّة، والذي لا يزال مُتواصلاً بوتيرة سريعة منذ أكثر من سنتين حتى اليوم، هو في النهاية مسؤوليّة الدولة والسُلطة في لبنان. ومُعالجة هذا الواقع المُزري الذي إنعكس بشكل سلبي وخطير على التفاصيل الحياتيّة والمعيشيّة لشرائح واسعة من الشعب اللبناني، هو مسؤولية الحكومة والسُلطات الحاكمة، أكانت تنفيذيّة أم تشريعيّة أو حتى إداريّة رسميّة. لكنّ هذه الحقائق لا تُعفي الكثير من الجهات الإقتصاديّة والمؤسّساتيّة في القطاع الخاص، من دورهم في الحد من حجم المأساة التي تدفع بإتجاه إغراق أغلبيّة الشعب اللبناني تحت خطّ الفقر، بسبب خلل هائل في الرواتب بالنسبة إلى كثير من العاملين. وفي هذا السياق، يُمكن تعداد ما يلي:
أوّلاً: إنّ مُختلف أصحاب المؤسّسات والمحال التجاريّة، قاموا برفع قيمة البضائع والسلع التي يُسوّقونها ويبيعونها، إنطلاقًا من التضخّم الهائل الذي حصل. فإذا ما قُمتَ بالتسوّق في أيّ متجر صغير أو في "سوبرماركت"، ستجد أنّ الأسعار تضاعفت مرّات عدّة. والسعر الذي كان مُعتمدًا قبل سنتين، صار اليوم مَضروبًا أقلّه بستّ أو سبع مرّات وُصولاً إلى 15 مرّة بالنسبة إلى الكثير من السلع والبضائع، وحتى إلى 20 مرّة في بعض الحالات! وبالتالي، حتى لوّ تراجع مبيع هذه المتاجر، أكانت صُغرى أم كبرى، وحتى لوّ تغيّرت طبيعة ونوعيّة و"ماركات" السلع والبضائع التي يبيعونها، فإنّ نسب الأرباح التي يُحصّلونها واكبت التضخّم، بحيث حافظ المسؤولون عن هذه المتاجر على مدخول مرتفع. أكثر من ذلك، هذه الأسعار لا ترافق إرتفاع سعر صرف الدولار فحسب، بل تسبقه بأشواط في أغلب الأحيان، من دون أيّ حسيب أو رقيب!.
ثانيًا: إنّ مُختلف أصحاب المهن الحُرّة، قاموا بدورهم برفع قيمة الأتعاب التي يتقاضونها، بما يتناسب مع حجم التضخّم الحاصل، ومع غلاء الأسعار الفاحش. وهذا الواقع ينطبق مثلاً على الكهربائي والسمكري كما على الحلّاق ومُصفّف الشعر والعامل مقابل أجر يومي، وينطبق أيضًا على الخيّاط وسائق سيارة الأجرة كما على الطبيب أو مهندس الديكور على سبيل المثال لا الحصر أيضًا. وهو يطال كذلك الأمر، كلّ شخص يعمل لحسابه الخاص بمهنة حرفيّة أو يدويّة أو حتى خدماتيّة، إلخ. وبالتالي، كل هذه الفئات من العاملين واكبت حال التضخّم، ورفعت قيمة ما تتقاضاه من أتعاب ورسوم، من دون إنتظار أي تصحيح عام للأجور، وهي حدّدت الزيادات وفق مزاجيّة خاصة لا ترتبط بأيّ قاعدة إقتصاديّة أو ماليّة يُمكن البناء عليها.
ثالثًا: بالتالي إنّ الفئة الأكثر تضرّرًا من الإنهيار الحاصل، هي التي تعمل في القطاع الرسمي بمختلف أقسامه المدنيّة والعسكريّة، وكذلك التي تعمل في القطاع الخاص، وبالتحديد تلك التي لم تحصل على أيّ زيادات تُذكر أو على زيادات مَحدودة جدًا. بالنسبة إلى العاملين في القطاعات الرسميّة، والذي كانوا قد إستفادوا عشيّة الإنتخابات النيابيّة الماضية من زيادات كبرى على رواتبهم، بحيث فاقت رواتبهم رواتب الكثير من نظرائهم في القطاع الخاص، يُعانون اليوم من تآكل قدراتهم الشرائيّة، لأنّ رواتبهم لم تتغيّر. لكنّ هذه الفئة تتخلّف اليوم عن القيام بدورها الوظيفي بموافقة ضمنيّة وغضّ نظر من قبل المسؤولين المعنيّين، وهي بالتالي عوّضت ضُعف قيمة الراتب بعدم الذهاب إلى العمل إلا في ما ندر، علمًا أنّ قسمًا كبيرًا من هؤلاء يعمل في القطاع الخاص بشكل مُواز لعمله في القطاع الرسمي.
رابعًا: بالنسبة إلى العاملين والموظّفين في القطاع الخاص، فهم الأكثر تضرّرًا على الإطلاق من الأزمة، حيث أنّ رواتبهم لم تعد تكفيهم لشراء المأكل والمشرب لبضعة أيّام من كلّ شهر، فكيف بالحري تأمين المُسلتزمات والمُتطلّبات الحياتيّة ككلّ! وحتى تاريخه، إنّ التصحيح الذي لحق بأجور هذه الفئة محدود جدًا، وهو جاء بقيمة مُتفاوتة جدًا بين شركة وأخرى وبين مؤسّسة وأخرى. وفي هذا السياق، قام بعض أرباب العمل بدفع نسبة مئويّة صغيرة من الرواتب بالدولار الأميركي، أو حتى بما يُسمّى "اللولار" المصرفي الذي إرتفع أخيرًا إلى حدود 8000 ليرة لبنانية لكل "لولار". والبعض الآخر إكتفى بزيادة طفيفة للراتب بالعملة الوطنيّة، ما جعل هذه الزيادة فاقدة تمامًا لأيّ قيمة شرائيّة، بسبب سرعة غلاء الأسعار. والمُشكلة أنّ أصحاب الشركات ومؤسّسات العمل الخاصة، يعتبرون أنّ الأعمال التجاريّة والخدماتيّة-على أنواعها، هي في حالِ ركود وتدهور، وأنّ الأرباح والمداخيل مُتراجعة حكمًا نتيجة لذلك، وبالتالي لا قُدرة على صرف زيادات تعيد التوازن بين ما يبذله الموظّف أو العامل من جهد، وما يتقاضاه من راتب. وهذا الواقع، جعل العمل في كثير من المؤسّسات والشركات أقرب إلى السُخرة، علمًا أنّ المسؤولية الأساس تقع بالدرجة الأولى على السُلطة التنفيذيّة التي عليها إجتراح الحلول لوقف الإنهيار، وإقرار قوانين مُلزمة لرفع الرواتب والأجور، طبعًا بعد إعادة التوازن إلى ماليّة الدولة، منعًا لمزيد من التدهور والتضخّم. ودور القطاع الخاص في المرحلة الحالية يقتصر على مُساعدة الموظّفين والعمّال على الصُمود لأطول فترة مُمكنة، من ضُمن الإمكانات المُتاحة.
في الخلاصة، تُطبّق أغلبيّة من اللبنانيّين اليوم مقولة Sauve qui peut في حياتها اليوميّة، بحيث يُحاول كل لبناني النجاة بنفسه بمنأى عن مصير الآخرين، وهذا الواقع نجح مع البعض ولم ينجح مع البعض الآخر، بسبب الإختلاف في أماكن العمل وطبيعة المهن والوظائف، وبالتالي بسبب إختلاف كبير في قيمة الرواتب المَدفوعة أيضًا.