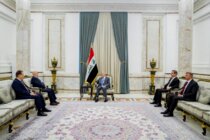من فظائع الحقبة الحريرية المستمرة حتى اليوم، أن الجمهور المفترض لتيار المستقبل، وناخبي فريق 14 آذار، هم أكثر من يخرج إلى الشوارع احتجاجاً على الأزمات المعيشية المتفاقمة. وإذا كان صمت بقية القواعد الشعبية لا ينمّ عن مسؤولية كبيرة، إلا أن الانتفاضة المستمرة لهذا الجمهور تدعو إلى الحيرة في أمر الجمهور نفسه. ذلك أن في قضية كقضية النفايات، لن يكون في الإمكان وضع أحد في قفص الاتهام فيها، سوى اثنين من قادة هذا الفريق: سعد الحريري ووليد جنبلاط!
كانت الصفقة السورية مع هذه الطبقة تقضي بترك أمور البلاد الاقتصادية والحياتية لفريق من المتنازعين على المال العام، مقابل تخلي هؤلاء عن السياسة الاستراتيجية. ومن قبل من المسيحيين بالدخول في جنة الحكم تحت الوصاية السورية، كان قد ضمن مسبقاً نصيبه من كعكة الدولة. وحتى عندما حصل الانقلاب الكبير في عام 2005، حافظ هذا الفريق السياسي على كل نفوذه داخل الدولة، وواصل قضم الدولة والمال العام، لكنه صار في حل من التزامه السياسي، فمارس الخيانة الوطنية بكل أشكالها، وخصوصاً في احترافه التآمر على المقاومة.
من خارج هذه الطبقة، أُقنع حزب الله وتيار المقاومة بأن من الأفضل، لحماية خياره وبرامجه، غض النظر عن ارتكابات هذه الطبقة مقابل بلعهم لألسنتهم الحاقدة على المقاومة. وكانت التسوية ــــ المقايضة مع الحريري الأب ثم مع الحريري الابن.
وهناك قوى لها نفوذها، مثل «القوات اللبنانية»، خسرت رهانها على تطورات إقليمية بداية التسعينيات، فطارت من جنة الحكم، وعندما أُفرج عنها قبل نحو عشر سنوات صارت شريكة في القرار، مع قدر من المنافع التي تركز على الدخول في مؤسسات الدولة، وتلقي دعم خارجي، ولا سيما أن الجمهور لم ينس ما جمعته قسراً من أموال خلال سنوات الحرب.
أما التيار الوطني الحر، فصوته المرتفع مطالباً بإصلاح جذري وشامل، لم يترافق مع آلية نضالية تبقي حضوره في الشارع موازياً لحضوره المستجد داخل مؤسسات الدولة. ثم جاءت استحقاقات كبيرة لتفرض حسابات من النوع الذي يجعل التيار في موقع غير الراغب في صدام مع الجميع. علماً أن ما يحصل أخيراً مع العماد ميشال عون، لا يعني إلا شيئاً واحداً: لم يغير هؤلاء حرفاً في نصهم الرافض لعون وتياره.
عندما جاء إميل لحود إلى الحكم، انطلقت معركة الحريات العامة وحقوق الطوائف، وبدا أن محاولة التصدي للفساد لها كلفة على صعيد السلم الأهلي، ومع ذلك، عشنا عشر سنوات على الأقل، نسمع فيها تبادل اتهامات حول سرقة المال العام وهدره. الكل يتهم الكل، انطلاقاً من كون الكل أخذ حصته من مؤسسات الدولة الخدماتية إلى جانب السلطات.
وفي مراجعة بسيطة يمكن ملاحظة الآتي:
ــــ أولاً: إن المجالس والصناديق والمؤسسات العامة الملحقة برئاسة الحكومة لا تزال تخضع للسيطرة السياسية والإدارية نفسها التي كانت تحتها منذ 25 عاماً، وبالتالي إن ختمها بالشمع الأحمر اليوم، وفتح دفاترها، والعودة بالحسابات والمصاريف والمشاريع والشركات العاملة منذ اليوم الأول حتى يومنا هذا، سيوفر لنا أجوبة عن حجم الهدر والسرقات. بالإضافة إلى كشف المستور حول التخطيط العشوائي أو غير العلمي. وعندها نعرف حقيقة هوية السارقين والناهبين، ونلاحقهم في الشوارع إن لم يقم قضاء يتولى أمرهم.
ــــ ثانياً: إن غالبية ساحقة من الشركات الخاصة التي تولت إنشاء أو إدارة مرافق عامة، بعضها ملك الدولة بصورة كاملة، وبعضها الآخر يخضع لقوانين خاصة، هي شركات حصلت على حصتها في الاشغال ربطاً بعلاقتها مع الطبقة السياسية. ورجال الأعمال في بلد مثل لبنان، يرفعون صوتهم الطائفي والمذهبي وهم يتجهون لفض العروض، ثم تجدهم جميعاً بلا طائفة عندما يذهبون لتحصيل ما يقولون إنه عائداتهم. وهؤلاء ليسوا أنبياء ولا أتقياء، وليس محرماً إخضاعهم لعملية التدقيق نفسها.
ــــ ثالثاً: إن المنظومة المتحكمة بالسياسات المالية والنقدية في لبنان، تجمع تحت خيمتها كل القوى الخاضعة للطبقة السياسية أو حتى لعواصم خارجية، وهي موجودة بأسماء وعناوين واضحة وغير قابلة للتشكيك، وتكفي نشرة واحدة من مصرف لبنان، أو بعض أرشيف لجنة الرقابة على المصارف، حتى يكون في مقدور اللبنانيين معرفة كل شيء.
حسناً، يبدو الكلام الوارد أعلاه، مجترّاً، ومكرراً ومعلوكاً، ولن يؤثر في شيء. وهذا صحيح. لكنها حقيقة، ستظل أولوية عند الذين ينتظرون يوماً يتاح لهم محاكمة ناهبي المواطنين ومصاصي دمائهم.
ومع ذلك، فالسؤال، يجب أن يكون موجهاً، حقيقة، إلى الجمهور، الرأي العام، الذي لا يريد قلب الطاولة. بعضه يخشى الفوضى وهو محق، وبعضه الآخر يخشى الانزلاق نحو حروب أهلية طائفية ومناطقية، وهذا صحيح أيضاً، وبعضه الثالث يقبل بتسويات من نوع ما يقوله الناس اليوم: ارفعوا الزبالة من الشوارع وارموها حيث تريدون!
لكن كل ذلك لن يكفي. الناس في لبنان ليسوا أحراراً، وليسوا مكتملي النمو الإنساني، وليسوا أهل دولة عادلة ومستقرة وقابلة للازدهار. ولذلك، ستبقى البلاد على شاكلتهم، ولن تكون لها صورة مخالفة لصورتهم، كأشخاص ضعفاء ومهانين، وأصحاب عصبيات عمياء، ولا عجب أن تلفهم الروائح النتنة حتى يوم الدين!