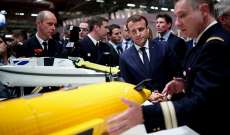- لا تملك السعودية المقدرة على القيام بمخاطرة بحجم حرب استنزاف مفتوحة في سورية، بلا حليف استراتيجي هو «إسرائيل» يضمن لها الإسناد الضروري من جهة، ويخفف من أيّ ضغوط أميركية محتملة ويتقاسمها معها من جهة أخرى. فـ»إسرائيل» تعلم أنّ استقرار سورية وفقاً للسيناريو الروسي الإيراني ترسيخ لمعادلة توازنات سيكون الأمن «الإسرائيلي» فيها وجهاً لوجه أمام محور المقاومة الصاعد بكلّ قواه، والمتمكّن من أسباب قوة تجمّعت وتنامت وتعاظمت في ظلّ حروب السنوات الأخيرة، و«إسرائيل» تعلم في المقابل أنّ الرهان على إسقاط سورية صار حلماً مستحيلاً يفوق قدرات كلّ الحلف الذي خاض الحرب عليها، وكانت واشنطن على رأسه، ولذلك عليها ابتكار ما يتيح الحؤول دون تعافي سورية واستقرارها من دون التورّط في الحرب التي تجلب عليها الكوارث، ورسم حدود تدخلها العسكري والاستخباري ضمن حدود ضيّقة لا تتسبّب بالحرب، والرهان على تشغيل قوى ودول لا تعيش ذات الوضعية الحرجة.
- ينطرح أمام «إسرائيل» خياران تسعى لدمجهما معاً، الخيار التركي الإخواني الذي يعد بالتعاون لمواصلة الرهان على «جبهة النصرة» لخط الحرب على سورية، والمقابل هو جذب حركة «حماس» إلى تسوية مديدة بمسمّى الهدنة وتتضمّن منح غزة ما يتيح القول «إسرائيلياً» إنها الدولة الفلسطينية النهائية، من دون أن يحرج «حماس» بإعلان التخلي عن الحقوق الفلسطينية والاكتفاء بالقول إنها هدنة توقف فيها أعمال المقاومة لخمس وعشرين سنة، ومقابله الخيار السعودي الذي يضع أولوية المواجهة مع إيران ويرى سورية ولبنان ساحتيها المباشرتين، ويتطلع نحو الشراكة مع «إسرائيل» طالباً الغطاء لهذا التحالف الاستراتيجي بمسرحية تسوية توحي بوضع القضية الفلسطينية على سكة الحلّ من خلال وعد بالدولة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة ولتكن البداية غزة، مع نوع من إدارة مدنية في الضفة، شرط أن يسبق ذلك عدم منح «حماس» بطاقة السلطة على غزة، بل جعل السلطة ضمن شراكة دولية إقليمية يتمثل فيها فريقا الحكم الفلسطيني في رام الله وغزة ويمنحانها قوة الشرعية، ويفتح ذلك الباب لحلّ تفاوضي مديد بلا أفق، يبرّر الشراكة الخليجية «الإسرائيلية» في المواجهة مع إيران.
- السؤال الذي يواجه أوروبا هو كيفية وقف العبث بالملف السوري، بما لا يجعلها ضفة التلقي السلبي لتردّدات الحرب وأزماتها ومخرجاتها، خصوصاً في ملفي المهاجرين والإرهاب. وقد بدأت الأصوات الأوروبية الصارخة تتسع دائرتها من أسبانيا إلى النمسا وصولاً إلى بريطانيا وقريباً ألمانيا وإيطاليا واليونان. والمفهوم الأوروبي للأمن ينطلق من أنّ وصول الحرب إلى طريق مسدود في بلوغ هدف التغيير الشامل يجعل حرب الاستنزاف استنزافاً لأوروبا نفسها. ويدعو الأوروبيون للإسراع بصياغة حلّ سياسي في سورية يبرّر الانخراط مع الدولة السورية في علاقات طبيعية وتعاون جدي لحلّ قضيتي المهاجرين والإرهاب، ويتقاطع هنا مع الرؤى الروسية والإيرانية، وبدأ يجاهر بالدعوة للتسليم بأن لا أمل يُرتجى من دون دور محوري للرئيس بشار الأسد، وعلى رغم المضمون الأقوى للموقفين الإسباني والنمساوي وذهابهما أبعد من الموقف البريطاني في الدعوة إلى الانفتاح والتعاون مع الرئيس الأسد كرمز للدولة السورية. إلا أنّ الموقف البريطاني أجاب على تساؤل عملي يتصل بآلية الحلّ السياسي، الذي بقي معطلاً عند غياب تفسير موحد روسي أميركي لبيان جنيف 2012 حول المرحلة الانتقالية، لجهة الإعلان البريطاني عن الاقتراب من التفسير الروسي الذي يقوم على إنجاز هذه المرحلة تحت ظلّ رئاسة الرئيس الأسد ومن ضمن المؤسسات الدستورية والتخلي عن الصيغة الانقلابية التي روّج لها الأميركيون والبريطانيون معاً، والتي تستعير النموذج العراقي في ظلّ الاحتلال الأميركي، بوضع سورية تحت الفصل السابع وتعليق العمل بالدستور السوري وتسليم هيئة حكم تشبه التي عينها بول بريمر للعراق بعد احتلاله وتصفق اليوم لها أطراف المعارضة وتعتبرها فرصتها للحكم من دون المرور بصناديق الاقتراع. والسؤال هو هل يمكن لهذا التحوّل الأوروبي عموماً والبريطاني خصوصاً أن يتمّ تحت العين الأميركية ومن دون موافقتها؟
- واشنطن المرتبكة والحائرة في الفراغ الاستراتيجي تتفرّج وتراقب وتنتظر، وربما تمضي شهوراً قريبة كذلك ريثما تتبلور النتائج التركية والاختبارات السعودية والروسية والإيرانية، وتتظهّر الهواجس الأوروبية مواقف واضحة من الخيارات، لتحدّد استراتيجيتها بين الانخراط في حلّ سياسي وفقاً للوصفة الإسبانية وانطلاقاً من الموقف البريطاني، أو الانخراط في الخيار السعودي «الإسرائيلي» ولو من تحت الطاولة بالتشجيع والدعم والتغطية، أم أن صناع النظريات سيبتكرون خياراً ثالثاً هو الانخراط المزدوج، من وحي الاحتواء المزدوج، ويقوم على الانخراط هنا وهناك، حلّ سياسي مع سورية الأسد، وحرب استنزاف مع السعودي و«الإسرائيلي»، واعتبار الكلفة التي يجب أن تدفعها الدولة السورية للحصول على التعامل معها بصورة كاملة ونهائية، هو توليها مهمة تصفية جماعات تنظيم «القاعدة» الموجودين في سورية والذين سيجلبون إليها، ومن دون الالتفات إلى مخاطر ذلك مرتين، مرة بإمكانية الانزلاق إلى الحرب الإقليمية، ومرة بخطر توسّع فعالية الإرهاب الذي يتغذى من جذب عناصره إلى ساحات الحرب، بدلاً من وهم التصفية التي يعتقدها البعض، وفقاً لما تقول الوقائع الأوروبية، التي كان تقييم الأمن الفرنسي لعدد العاملين النشطين فيها لحساب «القاعدة» قبل الأزمة السورية هو ثلاثمئة وقد صار اليوم ثمانية آلاف، ويتوقع إذا استمرت الحرب لخمس سنوات أن يصل الرقم إلى خمسين ألفاً.